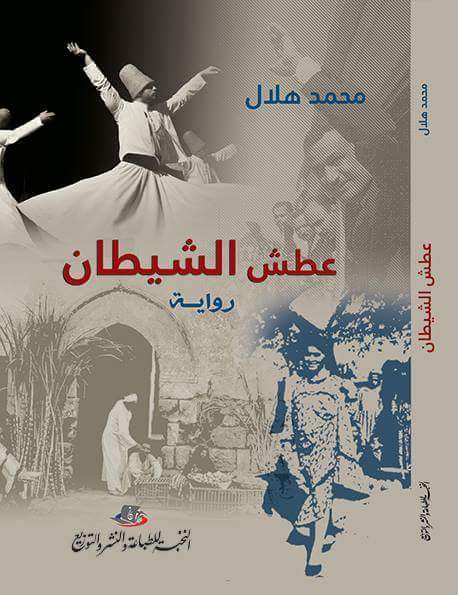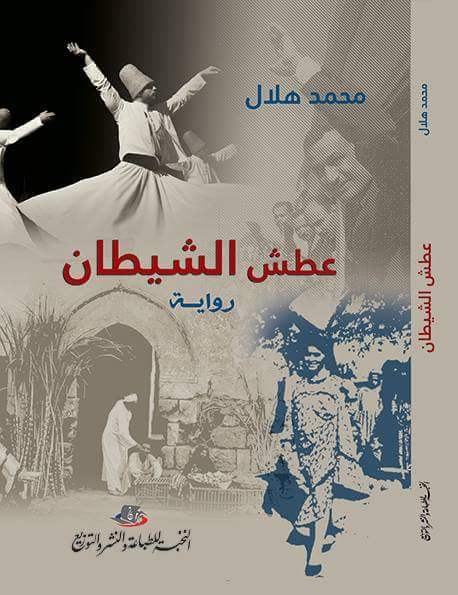يذكر حسين جيدًا، أول مكبر صوت اشتراه الأهالي، ليعلّق فوق المسجد، فقد كانت فرحة غامرة، وكان ورفاقه قد أنهوا عملية طلاء المسجد، ابتهاجًا بشهر الصوم الذي مضى منه أسبوع، أكمل فيه بعض الرجال جمع ما يكفي من المال، لشراء الميكروفون، وصنع له البعض الآخر، من جذوع الشجر ما يصلح لأن يعلق عليه، فوق سطح المسجد، وكأنه مئذنة صغيرة، كانت الحكومة، قد أطلقت التيار الكهربائي، بعدما اكتملت عمليات زرع الأعمدة الحديدية، وشد الأسلاك عليها، تلك العملية التي بدأتها منذ ست سنوات كاملة، حتى أصبحت جاهزة تمامًا لإنارة القرية.
بعد ساعتين، من ظهر العاشر من رمضان، كان مكبر الصوت جاهزًا تمامًا للعمل.
لم يكن الميكروفون، وحده الذي جاء به الأهالي لرفع الأذان، وخطبة الجمعة والأحاديث الدينية، وإنما اشتروا مذياعًا خاصًا بالمسجد، لمعرفة حلول وقت الصلاة، وكذا بث إذاعة القرآن الكريم، من خلال الميكروفون، وكانت فرحة كبيرة، تهللت لها قلوب الجميع.
لكن الفرحة الطاغية، حين فاجأ الراديو، كل الجماهير بالبيان الصادر، من الجيش المصري، بنجاح قواتنا المسلحة المصرية، في عبور قناة السويس، أكبر مانع مائي في التاريخ.. انطلق الصوت البطولي عبر الميكروفون، إلى عنان السماء، فتهلل الأهالي في فرح، أكبر من أن يوصف، هتف الكبير والصغير: اللـه أكبر، اللـه اكبر، اللـه أكبر. رقص من رقص، قفز إلى أعلى من قفز، حملت الفرحة الجميع، على أجنحتها وطارت بهم، أطلق عليه الناس ميكروفون النصر، راديو النصر، مسجد النصر، يوم النصر، وتساءل الأهالي فيما بينهم: ماذا يفعلون لمساندة أبطال النصر.
في المساء كان حسين وسط أترابه وشباب ورجال من القرية، يسهرون طوال الليل، على مداخلها، في نوبات للحراسة، متخذين من العصي أسلحة للتعامل، مع أي طارئ، وذلك بجوار الخفر الرسميين، أعلن راديو النصر وقتها، حالة الطوارئ في كل مكان، كان حسين يصنع من عصاة خشبية، ما يشبه البندقية يعلقها في كتفه، وفي داخلة احساس رائع بأنه، يؤدي دور وطني، ويحقق بذلك الحديث الشريف “عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية اللـه، وعين باتت تحرس في سبيل اللـه” وكان قد درسه في حصة الدين، بالمدرسة قبل أيام من المعركة.
عندما جاءت، إشارة وزارة الصحة ليلًا، بأن مستشفيات ميدان القتال، في حاجة إلى من يتبرع بالدم، لم ينم الناس حتى تنفّس الصبح، وبدأت شقشقة العصافير، لم يذهبوا إلى حقولهم، بادروا إلى المستشفي العام بالمدينة، في فرحة غامرة، كأنهم ذاهبون إلى عرس عزيز لديهم، في داخل كل منهم إحساس بالعزة والفخار، وكأنه يشارك فعليًا في الانتصار بدمه.
كانت المرة الأولى، التي تعرف فيها بيوت القرية، صورة الرئيس أنور السادات، فبعد ان تأكد الناس من أن أخبار النصر حقيقية، وأن جنودنا فعلًا، عبروا القناة، وأن طائراتنا بالفعل باغتت قواعد العدو، ودكتها دكا وليس كلامًا، كما حدث منذ ست سنوات في نكسة 1967، لم يجد الناس، ما يعبّرون به عن فرحتهم، إلا بالدعاء للجيش، بمزيد من النصر، والدعاء لصاحب قرار العبور، والبحث عن صور له ليحملوها، ويهتفوا بها.
لكن تعذّر الأمر، عندما رفض ناظر المدرسة رفضًا باتًا، إعارتهم صورة الرئيس، بحجة أنها عُهدة عنده، وإذا طاوعهم في ذلك سيروح – كما قال- في ستين داهية! لكنه اقترح عليهم، أن يذهبوا للهيئة العامة للاستعلامات في المدينة، فهي توزع صور الرئيس بالمجان .
على الفور امتلأت سيارة علي السفروتي للذهاب إلى المدينة ،حيث صور بطل النصر، بعد أن جاءوا بصور الرئيس السادات الملونة، دوى الهتاف والدعاء للـه أن يتم النصر، جعلوا يتأملون ملامح الرئيس .
ــــ انظروا يا جماعة للمكر، الذي يملأ عيني الرئيس؟
ــــ عليّ الطلاق بالثلاثة هذا ذكاء غير طبيعي.
ــــ فعلًا رجل يضحك على الديب، ويأكل غداه، ضحك على اليهود يا جماعة، الذين لا يقدر عليهم أحد.
فيما بعد قال الناس الكثير، عن دهاء الرئيس، الذي خدع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ونفذ خطته بعبقرية.. فيما بعد كثرت، حكايات الجنود العائدين بفرحة النصر، في ليإلى السمر، منهم من قال عن بطولات شارك فيها، ومنهم من حكى ما رآه للمرة الأولى، في حياته من طوابير الأسرى اليهود، ومنهم من أقسم، أنه كانت بينه وبين الأسير الشهير، الجنرال عساف يا جوري، مسافة مترين فقط وكان يتمنى أن يلسعه، على قفاه لولا خوفه من قائده، فللأسير حقوقه الإنسانية .
انتشرت الأساطير الكثيرة، عن العساكر الذين كانوا يلبسون، أبيض في أبيض، هؤلاء هم الذين أسروا القائد عساف يا جوري، وأسرى كثيرين غيره.
قال خطباء المساجد: إن هؤلاء الذين كانوا يرتدون، أبيض في أبيض، هم جنود اللـه من الملائكة، وذلك ليس بمستبعد على اللـه، فقد فعلها مع الرسول الكريم في موقعة كذا وكذا، انتشرت شائعات الملائكة، في كثير من المجالس، ومال البعض لتصديقها مؤكدين إن اللـه قادر على فعل المعجزات المدهشة، والبعض يحذرهم من تلك الخرافات لأن ذلك معناه أن جنودنا لم يفعلوا شيئًا .
قالوا: إن الرئيس المؤمن، الذي يحارب في شهر رمضان المبارك، وإن العساكر الذين يحاربون وهم صيام، لا بد أن يؤيّدهم اللـه بالملائكة.
بلغت البهجة ذروتها، عندما ظهر الرئيس السادات، في أول خطاب له بعد النصر، كادت قلوب الناس تستخرجه، من شاشات التليفزيونات، التي انتشرت بشكل غير مسبوق، حين تصارع الناس لشرائها مع أول بيان للنصر.
كثيرون منهم ، قاموا بتقبيل صورته على الشاشة، امتنانًا وشكرًا، كثيرون قالوا: فعلا كرامتنا رجعت بعد الذل، وكلما أعاد التليفزيون بث الخطاب، يتسمّر الناس من جديد أمام الشاشة، وكأنه سيقول شيئًا جديدًا، لم يقله المرة الأولى.
جعلوا يتكلمون، عن ذكاء الرئيس، مكر الرئيس، دهاء وإيمان الرئيس، الذي يذكر اللـه في أول كلامه، ووسطه وختامه. قالوا: إن رجلًا بهذه الصفات، لا بد أن ينصره اللـه.
للمرة الأولى عرفت حوائط البيوت، صور الرئيس السادات.
من الطرائف، التي تحملها ذاكرة القرية، أن سقطت إحدى طائرات العدو، محطمة في قرية تسمى “الطيارة”، فكان الناس يضحكون ويتندرون على ذلك، قائلين: الطيارة وقعت في الطيارة. ومن طرائف هذه الواقعة، أن الطيار الإسرائيلي، كان يتكلم اللهجة المصرية، حاول إفهام الناس أنه مصري، بعد أن اصطادوه من أحد الحقول، كان قد تمكن من القفز سليمًا، من الطائرة بكرسي النجاة المعدّ لذلك، لكن الناس لم يصدقوا كلماته، احتجزوه أسيرًا، حتى جاءت السلطات لتأخذه، لم يتعاطف معه أحد على الإطلاق، رغم تأكيداته العديدة أنه مصري، ومن البلد الفلاني، ومن القرية الفلانية، وابن الحاج فلان، لكن بعض الأهالي، ضحكوا مستهزئين، وهم يقولون: الْعب غيرها يا صهيوني.
برر الناس فيما بعد، عدم التعاطف معه، بأن قلوبهم، لم تصدق أقواله.
أما اسم قرية الطيارة، فلا علاقة له بما حدث، وإنما يعود إلى زمن قديم، ورجل فقير زاهد، لا يعرفه أحد. كان يقيم بالمكان، بعيدًا عن الخلق، ابتنى لنفسه طيارة، تقيه حر الشمس، فالطيارة في عُرف الفلاحين، تتكون من أربعة فروع، من الشجر مثبتة في الأرض، ومشدود في أعلاها فروع، أقل سمكًا تحمل السقف، المكون من القش والحطب، بينما جميع جوانبها بلا حوائط ، يطير فيها الهواء كيفما شاء، يستظل تحتها الناس والبهائم، ومن هنا جاء اسم الطيارة.
كان كل من يرِد إلى المنطقة، يتبرك بالرجل، ويبتني بيته الريفي، بالقرب من طيارة الشيخ الفقير الزاهد، ولما كثرت البيوت، أطلقوا عليها، اسم عزبة الطيارة.