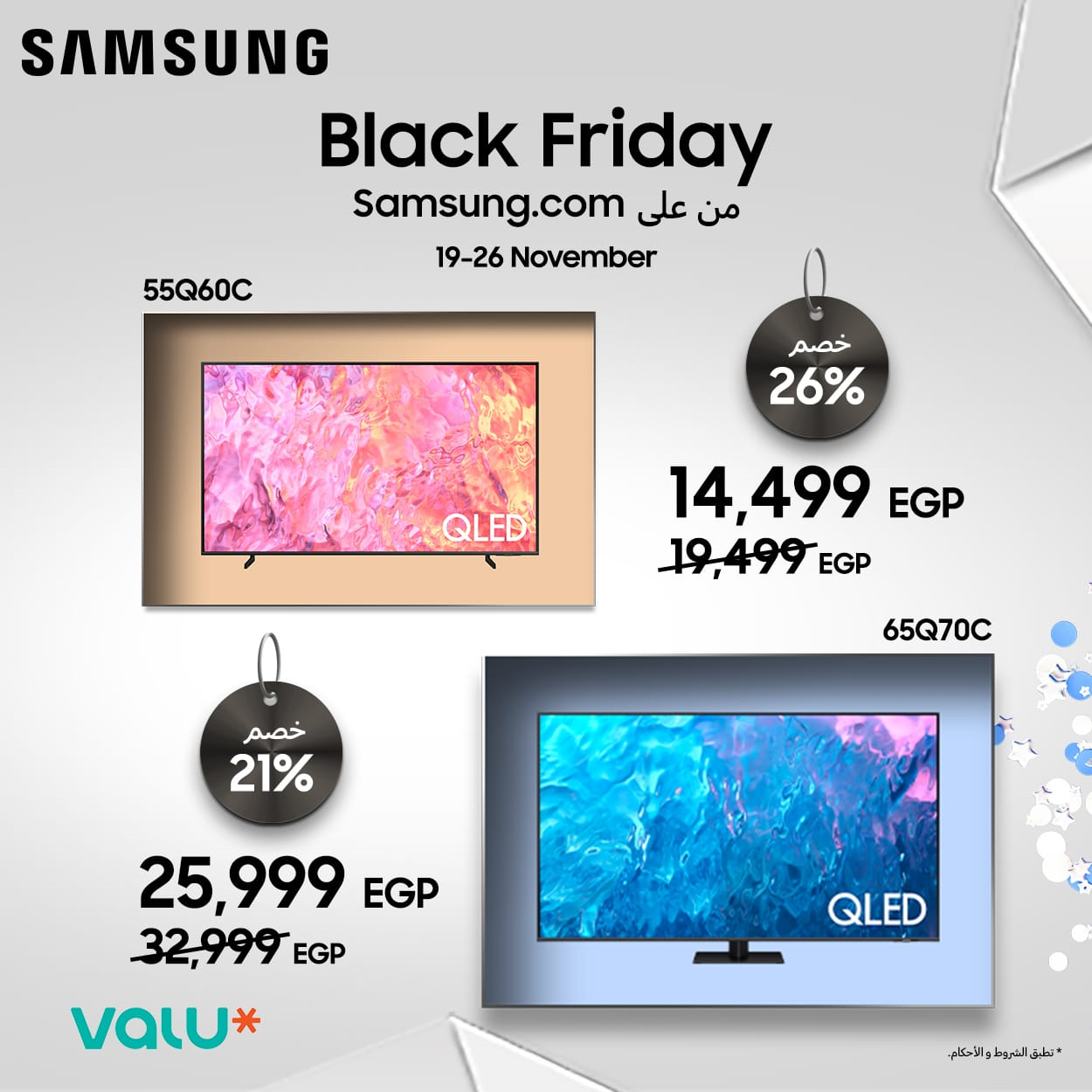كتب عادل يحيى
تعد “حلقة القاهرة النقدية”، التي يتولى إقامتها اثنان من خيرة المبدعين والنقاد، هما الصديقان العزيزان الشاعر الكبير المبدع سامح محجوب ، مدير بيت الشعر، والصديق وزميل الدراسة الشاعر الناقد الكبير المبدع د.أحمد حسن ، إرهاصا بميلاد فكر نقدي جديد، تمثله أجيال مختلفة من نقادنا المعاصرين، وهم وإن كانوا يبنون على تراث من سبقوهم من نقادنا ومفكرينا السابقين، فإن لكل منهم صوته المائز، على صعيد الدراسة الأدبية والنقدية، ولعل من يحضر فعاليات “حلقة القاهرة النقدية”، التي تقام في بيت الشعر (بيت الست وسيلة)، يلحظ ما نشير إليه بوضوح، فمن خلال مناقشة المنجز النقدي لأحد نقادنا المعاصرين، على اختلاف أجيالهم وأعمارهم، نقف على مدى إسهامه في ميدان الدرس الأدبي والنقدي خاصة، والفكري عامة، وبالجملة نؤطر مشروعه الفكري ومدى تأثيره في الحياة الثقافية والاجتماعية، سواء في مصر، أو على المستوى العربي، أو العالمي لمن تتجاوز أعمالهم إقليمنا، ترجمةً وكتابةً بمختلف اللغات.
ولعل من حسنات هذه الحلقة، أيضا، أنها لم تغفل حق التعليق والمناقشة من جانب الحضور (المتلقين)، بعد انتهاء ضيوف المنصة من المناقشة وإلقاء الضوء على أعمال من يتم اختياره من النقاد، من هنا يحدث حوار فاعل خلاق، يعد بمثابة العصف الذهني لكل الحاضرين، نقادا ومبدعين، وعامة، على السواء.
وكنت قد حضرت، مؤخرا، حلقة ناقشت المشروع النقدي والإبداعي للصديق الناقد الكبير المبدع الأستاذ الدكتور محمد سليم شوشة ناقشه أستاذي الصديقين العلمين العزيزين الدكتور خالد أبو الليل ، الأستاذ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور يسري عبدالله ، الأستاذ في كلية الآداب بجامعة حلوان، و الناقد الأستاذ الدكتور شحاته الحو ، الخبير في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وقد تناولوا باستفاضة ملامح المشروع النقدي والإبداعي للصديق محمد سليم شوشة، معرجين على منهجه النقدي، الذي يركز على الجانب الجمالي في دراسة النص، عبر الاتكاء على المناهج النقدية الحديثة، وأنه لم يكتف بدراسة الإبداع المعاصر، بل ضرب بسهم في دراسة الأدب العربي القديم، وأبرز الأمثلة على ذلك دراسته عن: البنية السردية عند الجاحظ، ودراسة الشعر الأموي والعباسي، ما منح دراساته سمة الشمول والموسوعية، فهناك دراساته عن السرد الحديث، كما نرى في: “الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الخطاب الروائي”، و”الذات والمرآة..صورة الرجل في السرد الروائي النسوي بين التشكيل والتأويل”، ودراسته عن شعر العامية في مصر، وغيرها.
وإذا كان الأساتذة المناقشون للمشروع النقدي لمحمد سليم شوشة، قد أشاروا إلى اهتمامه بالجانب الجمالي في دراسة النص، وأنه متأثر في ذلك بالجانب الإبداعي لديه، فإن مداخلتي قد اتفقت معهم في هذه النقطة، لكن الكاتب في أحد حواراته الصحفية معي، قد أشار إلى اهتمامه وتبنيه المنهج الإدراكي في تناول النص بالتحليل والنقد، بقوله:
“لدي استقرار منذ سنوات على المنهج الإدراكي لأنه منهج يتسم بالشمول وبالطابع العلمي والانضباط المنهجي وهو الأكثر هيمنة وقوة الآن في مناهج النقد الأدبي لدى الغرب وبخاصة في النقد الأمريكي، والحقيقة كذلك أنه منهج يتسم بالتشعب ويفيد من كل المناهج الأخرى، فينفتح على الفلسفة وعلم النفس بشكل حتمي وطبيعي، لأن الإدراكيات تنشغل بالعقل وبالسلوك والتكوين النفسي من خلال علم النفسي الإدراكي، كما أنه يفيد من المناهج الأخرى ولا يهمل ميراث الحداثة وما بعدها، لذلك فهو المنهج الذي يصل الماضي بالحاضر بنوع من التكامل والمرونة، كما لا يمكن إغفال إفادته من علوم الطب والتشريح والعلوم العصبية والذكاء الاصطناعي ودراسات الدماغ البشري وما يتم فيه من عمليات، وهو مجال كلما اكتشفنا فيه شيئا أثر ذلك على فهمنا الدقيق للغة والأدب أو الإبداع. والجميل كذلك في المنهج الإدراكي أنه لا يهمل اللغة وجذورها أو أصولها ويرتبط كذلك بالأنثروبولوجيا والأركيولوجيا والدراسات الشعبية ويربط بين الأدب والفنون الإبداعية المختلفة؛ أي أنه يعمل في المنطقة الرابط بين الإبداع بأشكاله المختلفة، وهكذا فإنه يصبح منهجا قويا في مقاربة الشعر والسرد والخطابات والأنواع الأدبية كافة. فالمتميز في النقد الأدبي الإدراكي سوف يكون قادرا على فهم السرد والشعر وفهم الخطابات الأخرى من الأدب الشعبي، كما أنه سيكون قادرا على ربط الأدب بالتكنولوجيا، ولن يكون محصورا في زاوية بعينها، والأهم أن هذا سيحدث وهو في غاية الانضباط المنهجي، وأتصور أن المستقبل سيكون للنقد الأدبي الإدراكي الذي يهيمن الآن بشكل كامل على المشهد النقدي في أمريكا منذ أواخر التسعينيات، وهو في تنام وتصاعد فاستحوذ على النسبة الأكبر فيما يكتب ويطرح من نقد” (الحوار منشور في جريدة الجمهورية وموقعها الإلكتروني).
وتطبيقا على هذا، يمكن أن نشير إلى مقتطف من تحليله لرواية “مسرى الغرانيق في مدن العقيق” للروائية السعودية أميمة الخميس، إذ يقول:
ثمة جانب مهم في شخصية الرجل في هذه الرواية، وهو ذلك الذي يجعل منه نموذجا دالا على معارف العصر أو على نوع الإدراك المعرفي الخاص بهذا العصر، فالصورة الذهنية التي تكونت لهذه الشخصيات هي جزء من نسيج الإنسان في ذلك العصر في القرن الخامس الهجري، بما فيه من معارف وعلوم بأنواعها ومترجمات وأفكار كانت جديدة في ذلك الحين، وامتزاج هذه العلوم بغيرها من الخرافات والأفكار الميتافيزيقية والغرائبية، والحكايات والطرائف أو المرويات باختلاف أنواعها ومصادرها، فالرجل يصبح بوتقة لكل هذه المعارف ويضحى مرآة لها، ويكون دالا على عصره وعلى طبية المجتمع الذي يعيش فيه” ( ينظر كتابه: الذات والمرآة، سلسلة كتابات نقدية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠٢٤، ص٢٤).
فالمتأمل في هذا النص النقدي، يجد اتكاء على علوم النفس الإدراكي والفلسفة والأنثروبولوجيا، بالاضافة إلى الجانب الجمالي الذي تضافرت كل هذه العلوم لإبرازه، ويمكن أن يضاف إلى ذلك نصوص من دراسات الكاتب عن الأدب الشعبي، وقصيدة النثر، ودراسته الأخيرة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيرة على اللغة العربية والإبداع.
وأخيرا، أشير إلى أن هناك أوجه شبه بين الجانب النقدي للناقد الكبير الراحل الدكتور جابر عصفور، والدكتور محمد سليم شوشة، من حيث الاهتمام بالتراث وتطبيق المناهج الحديثة في دراسته، والانطلاق نحو الحداثة باتجاهاتها المتشعبة، وإن كان عصفور قد ركز على ترجمة معطيات النقد الحديث بأبرز أعلامه الغربيين، فإن شوشة يمتلك رصيدا ابداعيا في ميدان الرواية والقصة القصيرة يحتاج إلى الدراسة الأدبية والنقدية، وإن كنت آخذ على شوشة أنها لم يكتب في نقد المسرح العربي، وهو جدير بذلك، ولعله يفعل ذلك في قابل الأيام.