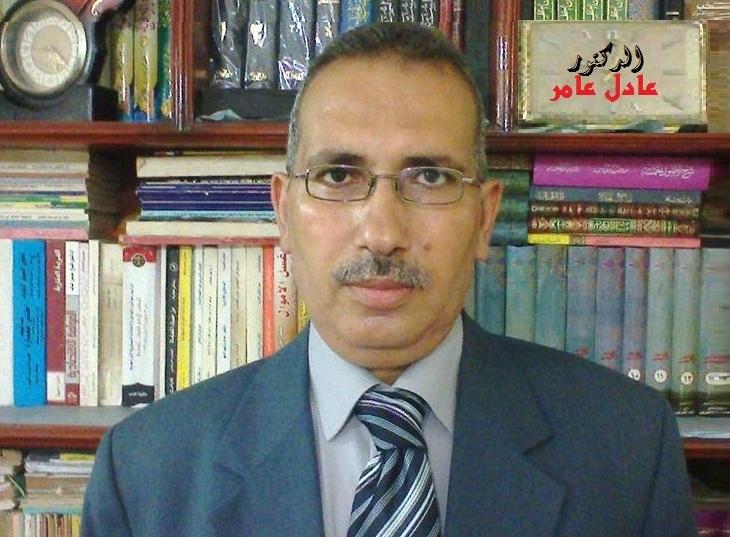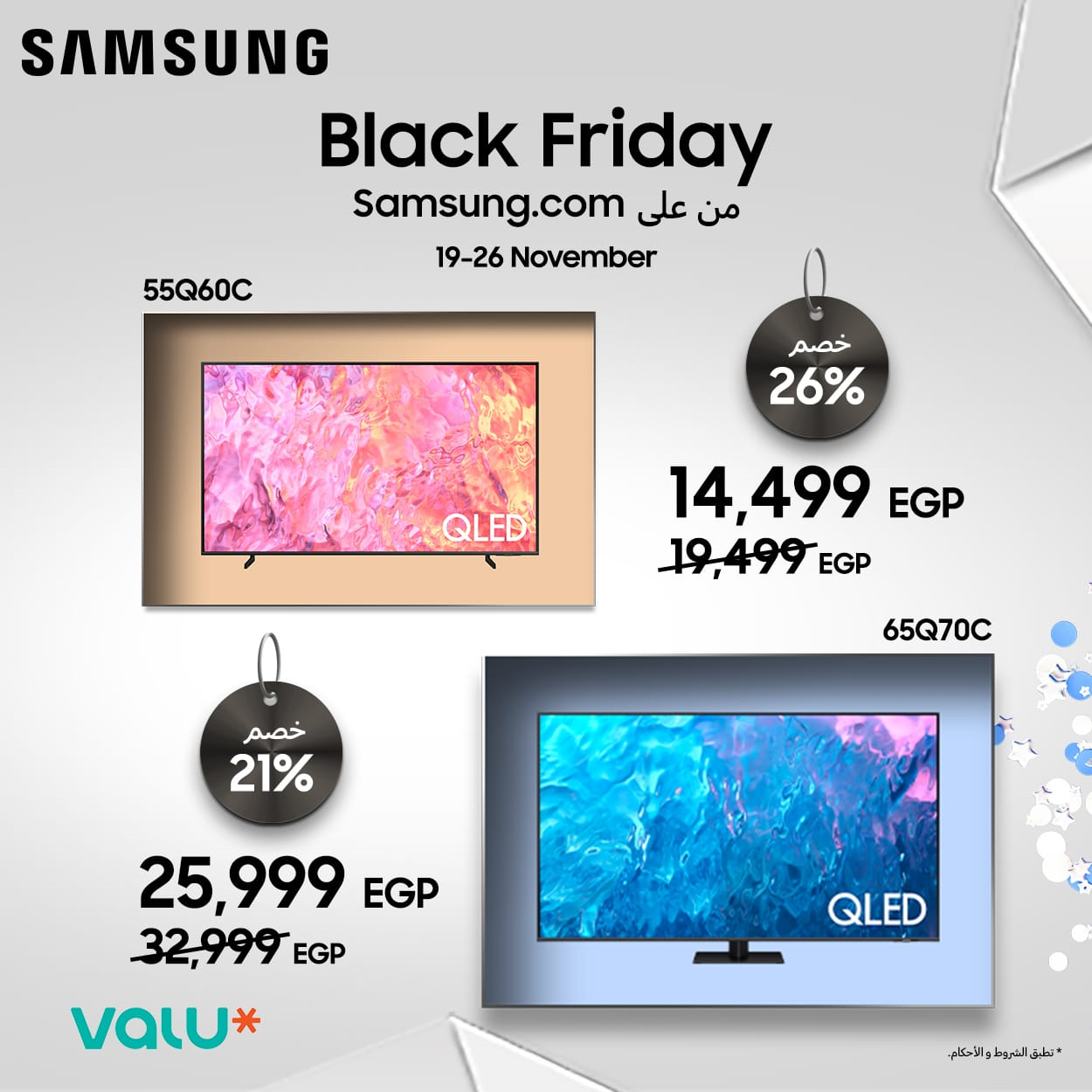يعد التعليم أحد أهم أعمدة بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور، وهو سبب نجاح الكثير من الأمم، فمثلا سنغافورة كانت دولة فقيرة، ونسبة الأمية فيها مرتفعة، أصبحت أحد أبرز الدول عالميا من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية وكلمة السر كانت التعليم، حيث تبنت الحكومات المتعاقبة منذ استقلالها عن ماليزيا في 1965 سياسات ومبادرات متعددة ومبنية على بعضها البعض كان من شأنها الارتقاء التدريجي بكافة مناحي العملية التعليمية من حيث: تطوير وتحسين المناهج، رفع أجور المعلمين، بناء المدارس، مما أدى إلى ارتفاع المستوى التعليمي كماً ونوعاً، مما ساهم في انتعاش اقتصاد الدولة ونموها السريع.
في المقابل تجد أن مشاكل التعليم متعددة ومتشعبة في العالم العربي، فمثلا تبلغ نسبة الأمية في العالم العربي نحو 19 في المئة، بينما تتلاشى تقريبا في الدول المتقدمة، أو ما يسمى بدول العالم الأول. أيضا تجد أن دخل المعلم يعد من الوظائف ذات الدخل المتدني المتوسط في الوطن العربي، بينما تعد من أعلى الوظائف دخلا في كندا، حيث يبلغ راتب المعلم الشهري فيها 5733 دولارا، تليها إيطاليا والهند وأمريكا بحسب مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكية.
يلاحظ أيضا أن عدد المدارس ووجود المرافق والأدوات اللازمة فيها محدود، بل يكاد يكون معدوماً في بعض المناطق الأقل حظاً من العالم العربي. هذا ويعاني التعليم الجامعي من الكثير من العيوب والمشاكل التي لا حصر لها: ابتداء بارتفاع تكاليفه، ومرورا بقدم مناهجه ومقرراته، وانتهاء بعدم تواؤم مخرجاته مع سوق العمل.
ومن الجدير بالذكر أن الإناث في الدول العربية يحظين بفرصة أقل من الذكور في التعليم، وخاصة التعليم الجامعي، حيث يتم حرمانهن منه لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد تارة، والفهم الخاطئ للدين تارة أخرى.
لا أظن أن تخلف الدول العربية يعود فقط لضعف التعليم، لكن أظن أن التعليم هو حجر أساس في نهضة أي أمة ترغب في النهوض، كما أظن أيضا أن كثيرا من ساسة الدول العربية لا يريدون النهوض بدولهم بشكل متعمد خوفا على سلطتهم ومنافعهم الشخصية. وفي حال توافرت الرغبة أنصح بمراجعة تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 لمعرفة الأسباب التي جعلت فنلندا أقوى دولة في التعليم في العالم.
تفتقر مخرجات التعليم في معظم الدول العربية لتلبي احتياجات سوق العمل، لأسباب منها عدم توافق التخصصات مع متطلبات السوق، وضعف الابتكار وريادة الأعمال، وقلة التدريب العملي والشراكات مع القطاع الخاص. أن الاستثمار في التعليم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدلات الفقر ورفع نصيب الفرد من الدخل، ما يعزز قدرة الدول على المنافسة في الاقتصاد العالمي. ورغم أن بعض الدول العربية بدأت تدرك أهمية إصلاح المناهج وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ولكن تعميم هذا النهج في البلدان جميعها يتطلب تخطيطاً دقيقاً يراعي احتياجات سوق العمل بشكل مدروس،
إن الاهتمام بتعليم “البزنس” أي التعليم الأهلي على حساب التعليم العام أو الحكومي له من الآثار السلبية ما هو كاف للقضاء على أي تقدم منشود في أي مجتمع.
فالتعليم العام يمثل البلد كله، وهو رمز ووجهة أي بلد عربي ودليل تقدمه ونهضته، كما أنه يربي وينمي الولاء للوطن، بينما التعليم الخاص باختلاف توجهاته ومشاربه، أعتقد أنه يغفل أشياء كثيرة، ويعجز عن أشياء جمة لا يمكن أن تتحقق إلا في التعليم الحكومي أو العام ، إن من أخطر الأخطار تخلي الحكومات عن التعليم بأشكال مقنعة مختلفة، والاتجاه نحو خصخصته في كل مراحله، لما في ذلك من قتل للوازع الديني والقومي والوطني السليم المرجو تحقيقه في الأجيال المختلفة.
ولكن التعليم ا لعالي في بلدان العالم الثالث بما في ذلك العالم العربي يواجه الكثير من العقبات والعراقيل، فلابد من تذليلها قبل التفكير بالدخول إلى هذا العالم. ومن هذه العقبات والعراقيل التمويل، كذلك انعدام البيئة الاجتماعية لمثل هذا المستوى من التعليم، أضف لذلك سياسة الأنظمة التي تريد الحفاظ على كيا نها قبل كل شي، ثم التأثيرات ا لاديولجية على التعليم، وجبر مساره باتجاه تصورات خاصة عن الكون و الحياة والمجتمع والدين والأخلاق وغيرها.
بعيدا عن التصنيفات، ما زال التعليم العام في الوطن العربي في حاجة إلى عدد من المتطلبات لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة، بحيث تكون العملية متكاملة وتحقق أهدافها المرجوة.
كلما اتجهت أبصارنا نحو مستقبل الوطن العربي وجدنا دائماً أن التعليم هو بوابة المستقبل وأن الأمم الناهضة بغير استثناء قد ارتبطت بهذه القضية المهمة ذات التأثير الكبير في حياة الشعوب ومسيرة الدول، خصوصاً في مراحل التحول الفكري والثقافي، فالتعليم هو المتغير المستقل الذي تتبعه مظاهر النهضة وأسباب الرقي، وهو يمثل قضية لا تقف وحدها في الفضاء ولكن تدور حولها دوائر متعددة تمثل المحاور التي تنتظم في فلك التعليم، وسوف نذكر منها محاور الثقافة والبحث العلمي والتدريب المهني والتشغيل والإعلام ودور المؤسسات الدينية، فهذه كلها ملحقات بالعملية التعليمية تتأثر بها وتخضع لأساليب الإصلاح التي تسلكها للأخذ بيد الأمة من خلال النهوض بالتعليم وتوابعه وملحقاته. دعونا نغوص قليلاً في هذه المحاور:
أولاً: إننا نعترف بأنه ليس كل متعلم مثقفاً ولكننا نزعم أن كل مثقف قد لا يكون بحاجة إلى التعليم النظامي، ولأن الأخير هو القماشة الكبيرة التي يتم منها تفصيل ملحقاته، لذلك فإن محنة التعليم تنعكس بالضرورة على بقية الملحقات، إذ ليس من شك في أن تدهور التعليم يؤدي بالضرورة إلى تراجع الثقافة وتدني سلوك البشر،
وسنكتشف أن الارتباط بين التعليم والثقافة إن لم يكن شرطياً فإنه يبدو طردياً، فإذا جرى إصلاح التعليم فإن ثقافة الشعب عموماً ستجد طريقها إلى الرقي والازدهار، ولو أخذنا النموذج المصري، بحكم ضخامة عدد السكان، فسنكتشف أن تراجع الدور الإقليمي وخفوت الإيقاع الثقافي ارتبطا معاً بتراجع مكانة التعليم المصري وضعفه في العقود الأخيرة، وهنا يجب أن ندرك أن النهضة صفقة متكاملة وأن التقدم له مؤشرات عدة يتصدرها التعليم الذي يمثل قاطرة الصحوة الوطنية مهما تعددت الأفكار واختلفت الأيديولوجيات، ونحن نعني بالتعليم هنا جدولة الذهن وترتيب العقل والمضي نحو آفاق الغد بخطى ثابتة وعقل متوهج وحماسة لا تفتر.
إن أزمة الثقافة العربية مرتبطة بمحنة التعليم التي شهدتها كثير من الدول العربية، ولقد قرأت أخيراً دراسة لمنظمة اليونسكو اعتمدت على مسح شامل لمستويات التعليم في الوطن العربي خرجت منه بأن مستوى التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أفضل منه بكثير في الدول العربية الأخرى. ثانياً: إن العلاقة بين التعليم والبحث العلمي مثل العلاقة بين المادة الخام والمادة المصنعة، فالبحث العلمي هو توظيف العلم في خدمة الصناعة ودعم التكنولوجيا التي تجلب أسباب الراحة والأمان للبشر،
فالعلاقة بين التعليم والبحث العلمي علاقة مركبة ومتداخلة، إذ لا يوجد بحث علمي متميز إلا من خلال تعليم جيد قد يؤدي بالضرورة إلى الاهتمام التلقائي بالبحث العلمي ولا يمكن أن يتحقق ذلك بمعزل عن إرادة الدولة من خلال سياسات الحكومات في الدول العربية المختلفة، ولو راجعنا الأرقام التي تنفقها الدول العربية على البحث العلمي منسوبة إلى الدخل القومي في كل بلد منها لوجدناها متواضعة إلى حد كبير، ونحن بهذه المناسبة نرد هنا على الذين يزعمون أن البحث العلمي يحتاج إلى نفقات باهظة وأموال طائلة، لأن ذلك لا يبدو صحيحاً على إطلاقه، فما زلت أتذكر كلمات صديقي الراحل الدكتور أحمد زويل في معرض تعليقه على ضعف البحث العلمي في دول الوطن العربي.
لقد قال لي رحمه الله إن الاكتشافات العلمية الحديثة وتطوير الاختراعات المختلفة لم تعد بحاجة إلى إنفاق كبير، فالشباب الأميركي يحاول قضاء وقته في دراسة المعادلات الرياضية وتصنيع الأجهزة الحديثة مستخدمين (كراجات) العمارات بحد أدنى من النفقات وبتكلفة محدودة للغاية! فمتى يستيقظ العرب ويدركون أن البحث العلمي هو الوليد المباشر لفكر النهضة في كل العصور والدول كافة!
ثالثاً: إن العلاقة بين التعليم والتدريب المهني هي العلاقة بين النظرية والتطبيق، إذ إن التفوق العلمي أو الحصول على شهادات عليا ليس مبرراً لكي يكون المرء ناجحاً في عمله، إذ لا بد أن يتأهل كل شخص لما سيقوم به ولذلك فإن التدريب عملية مهمة قد تزيد خطورتها عن التعليم ذاته، وإذا كنا في اختيار أمام شخصين أحدهما مدرب على العمل والآخر متفوق في الدراسة النظرية حول ذات الموضوع فإن الأولوية تكون لمن تدرب فعلياً على العمل وأدرك طبيعته مباشرة، وأنا أتذكر أن أحد وزراء الخارجية المصرية كان بصدد ترشيح مندوب دائم لمصر لدى الأمم المتحدة وكان أمامه ديبلوماسي كبير حصل على شهادة الدكتوراه في موضوع العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة بينما كان منافسه ديبلوماسياً لا يحمل الدكتوراه ولكنه عمل في المنظمة الدولية مرتين من قبل، فاختاره وزير الخارجية بلا تردد قائلاً: العبرة بمن مارس العمل لا بمن قرأ عنه أو كتب فيه، وأنا أظن أن التدريب المهني واحد من أهم لوازم الحياة لتأهيل الخريجين في حياتهم العملية،
إذ إن إتقان العمل وجودة الأداء يأتيان من التدريب على المهنة والتأهل لها مهما كان نوع المؤهل الدراسي ودرجته، وأنا أحسب أننا في الدول العربية أشد الناس حاجة إلى التدريب المهني وإلى نوعية من التعليم الفني فوق المتوسط الذي يتيح لصاحبه أن يسد حاجة مطلوبة في مشروعات التنمية والبناء، ويذكرني ذلك بنظام «البوليتكنيك» المعمول به في التعليم البريطاني. رابعاً: إن مشكلة المشاكل في بعض الدول العربية وفي مقدمها مصر أن المعروض من الخريجين لا يلتقي مع الطلب عليهم، فالعلاقة بين العرض والطلب ليست قائمة، وقد نرى عرضاً لنظام تعليمي متجمد منذ منتصف القرن الماضي يحاول أن يلتقي مع الطلب في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين وهذا هراء وعبث،
لذلك فإن البطالة في مصر هي بطالة نسبية، فالعاطلون في معظمهم لا يملكون خبرات واضحة تؤهلهم لأن يفكروا في الطريق الصحيح للمستقبل وأن يختاروا العمل الجديد، وقد ترى بعض رجال الأعمال يبحثون عن العمالة النادرة فلا يجدونها بينما يبحث مئات الآلاف من العاطلين من عمل فلا يجدون لأنهم غير مؤهلين له ويمكثون كذلك في طوابير انتظار لسنوات عدة وكان الأولى بهم أن يرفعوا من كفاءتهم
وأن يضيفوا إلى خبراتهم ما يجعلهم مؤهلين لسوق العمل الحالية، وأنا أدعو الجامعات في عالمنا العربي والمعاهد المتخصصة لأن تربط أعداد الخريجين بالطلب على التشغيل لأن الذي يحصل على شهادة ثم لا يعمل يبدو كالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار ويتجه نحو الانخراط في سلك الإرهاب أو إدمان المخدرات أو احتراف الأعمال غير المشروعة. خامساً: إن العلاقة بين التعليم والإعلام بكافة أدواته علاقة وثيقة ففي الدول التي ما زالت فيها الأمية تمثل مشكلة يكون جهاز التلفزيون هو أداة للتعليم والترفيه في الوقت نفسه ويتحمل القائمون عليه بالتالي مسؤولية تشكيل العقل الجمعي والضمير الذي يسود في مناخ سياسي واجتماعي معين، وإذا كنا نعيش عصر ثورة المعلومات فإن التعليم يمثل الخلفية الطبيعية لأدوات الإعلام المختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية بحيث يجب أن يتوخى الجميع الحرص الشديد في المادة الإعلامية إذا كان الخطاب موجهاً إلى المتعلمين
كما أن مسؤوليتهم لا تقل عن ذلك عند مخاطبة الأميين وفي الحالتين يبدو التعليم، بحضوره وغيابه، قاسماً مشتركاً للأهمية بين الحالتين، كما أن الإعلام يعتمد على كوادر متعلمة ومدربة يستطيع من خلالها اقتحام الحواجز التي تصنعها الأفكار المختلفة أو الآراء المتضاربة، كما أنه يجب ألا يغيب عن البال أن الإعلام هو الذي يحمل الرسائل المباشرة إلى المتلقي مهما كان مستوى تعليمه ودرجة ثقافته، من هنا تبدو خطورة الإعلام المعاصر واعتماده المباشر على القاعدة التعليمية. هذه رؤى للتعليم العصري في المنطقة العربية ومنه تتجلى خطورة ما حدث للمجتمعات العربية في العقود الأخيرة ومنه تتضح أيضاً خطورة العملية التعليمية وتأثيرها المباشر وغير المباشر في مفردات أخرى لها أهميتها في حياة الشعوب مثل قضايا الثقافة والبحث العلمي والتدريب المهني والتشغيل والإعلام ودرجة صمود المؤسسات الدينية أمام تيارات عاتية تحاول أن تقذف بها في أتون الإرهاب وتضعها موضع اتهام أمام جرائمه الشنيعة، ويبقى التعليم في النهاية هو مصباح علاء الدين الذي يقدم الحل السحري لكثير من المشكلات الراهنة في عالمنا العربي.–
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا