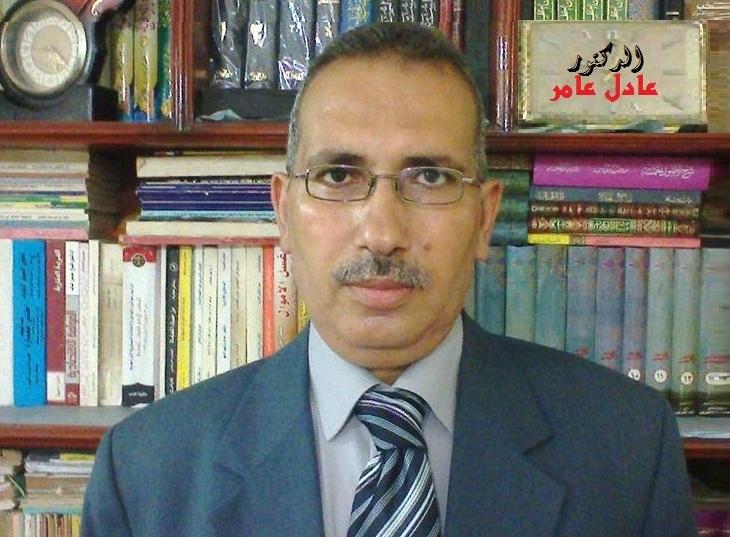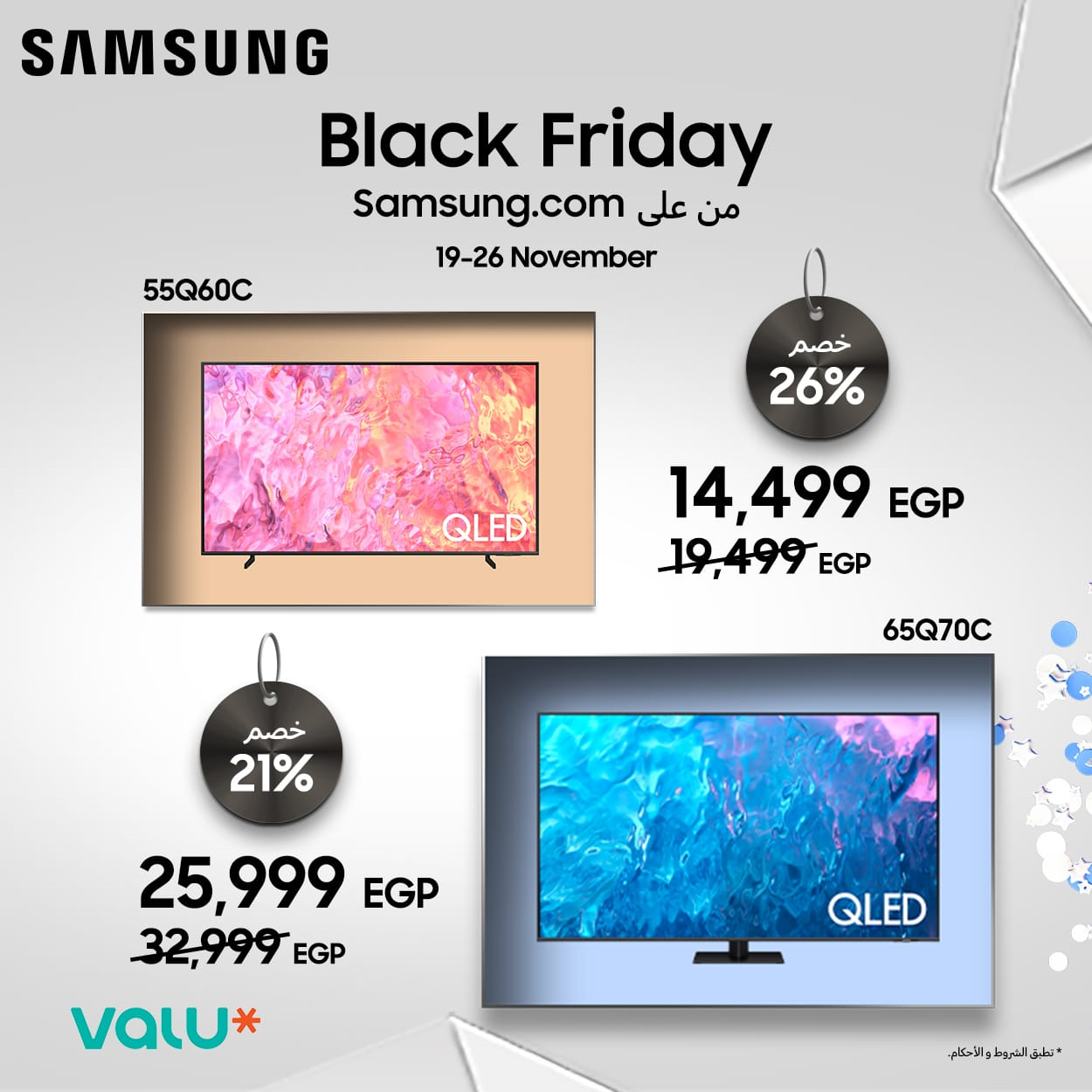من المحتمل أن تستمر المساعدات المقدمة لأوكرانيا حتى تتوقف المفاوضات، لكن الفكرة هي ممارسة الضغط على أوكرانيا من خلال التهديد بوقف المساعدات أو تقليصها تدريجيًا. وهنا يمكن للبيت الأبيض الاستفادة من الكونجرس في هذا الشأن، بالقول إن الهيئة التشريعية ترفض الموافقة على المزيد من المساعدات. من ناحية أخرى، يمكن لواشنطن أيضًا تعزيز المساعدات المقدمة لأوكرانيا مؤقتًا إذا رفضت روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
أنه خلال فترة ولاية ترامب الأولى، انخفضت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد، لكن التجارة العالمية الإجمالية أفلتت حتى من صدمة “كوفيد-19″، حيث غالباً ما وجدت السلع الصينية طريقها إلى الولايات المتحدة عبر ما يسميه صندوق النقد الدولي دول “الربط” مثل فيتنام. ويريد ترامب الحد من مثل هذا التحايل، لكن سلاسل التوريد العالمية يمكنها غالباً الابتكار بشكل أسرع مما يستطيع صناع السياسات التحرك. يواجه العالم موجة قلق واسعة بسبب السياسات التجارية والاقتصادية التي يتوقع أن ينتهجها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب خلال فترة ولايته التي بدأت قبل أيام، في عالم تتشابك فيه السياسة والاقتصاد بشكل وثيق، يأتي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة ليُحدث زلزالًا سياسيًا واقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط.
هذا القرار، الذي يتضمن السيطرة على غزة وإعادة توطين سكانها، ليس مجرد خطوة سياسية عابرة، بل هو قرار قد يُعيد تشكيل خريطة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة بأكملها. فما هي التداعيات الاقتصادية التي قد تنجم عن هذا القرار على دول الجوار العربية؟ وكيف يمكن أن تؤثر هذه التغيرات على حياة الملايين في المنطقة؟من الواضح أن القرار سيُفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد.
الدول العربية المجاورة مثل مصر والأردن ولبنان، التي تعاني بالفعل من تحديات اقتصادية كبيرة، قد تواجه تقلصًا في الاستثمارات الأجنبية بسبب تصاعد التوترات. فالمستثمرون الدوليون عادة ما يفرون من المناطق غير المستقرة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في هذه الدول.
ولا يمكن إغفال تأثير هذا القرار على أسواق البترول والغاز، التي تعد شريان الحياة للعديد من اقتصادات المنطقة. ففي حال تصاعد التوترات، قد تشهد أسعار النفط تقلبات حادة، مما قد يرفع تكاليف الطاقة على الدول المستوردة مثل الأردن ولبنان ومصر، بينما قد تستفيد الدول المنتجة مثل السعودية والإمارات من ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت. لكن هذه الفوائد قد لا تدوم طويلًا إذا تحولت التوترات إلى صراع مفتوح، مما قد يعطل إمدادات النفط ويؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله.
قطاع السياحة، الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا للدخل في دول مثل مصر، قد يتأثر سلبًا أيضًا. فالتوترات السياسية غالبًا ما تُبعد السياح، مما قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات السياحية وزيادة الضغوط على الاقتصاد المحلي. كما أن احتمال إغلاق المعابر الحدودية بسبب تصاعد التوترات قد يعوق حركة التجارة، مما يؤثر على سلاسل الإمداد ويُعطل تدفق السلع الأساسية.
أما بالنسبة للدول التي قد تستضيف نازحين من غزة – رضوخاً للضغوط الهائلة لأميركا – فإن العبء الاقتصادي سيكون كبيرًا. فهي بالفعل تعاني من أزمات اقتصادية حادة، واستضافة المزيد من اللاجئين قد يؤدي إلى استنزاف الموارد العامة وزيادة الضغوط على البنية التحتية والخدمات الأساسية. هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
ورغم أن هناك بعض التكهنات بوجود فرص استثمارية محتملة، مثل مشاريع البنية التحتية التي قد تطلقها الولايات المتحدة في غزة، فإن تحقيق هذه الفوائد يظل مرهونًا بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وهو أمر يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي. حتى الفكرة الطموحة بتحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” تبدو غير واقعية في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالمنطقة.
في النهاية، يبدو أن القرار الأمريكي بشأن غزة سيُحمل دول الجوار العربية تكاليف اقتصادية باهظة، بدءًا من تراجع الاستثمارات وصولًا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية القائمة. وفي ظل هذه التحديات، يظل السؤال الأكبر: هل ستتمكن دول المنطقة من الصمود في وجه هذه الضغوط الكبيرة التي تمارسها أمريكا وما يتبعها من عاصفة اقتصادية، أم أن القرار سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير؟ الإجابة ستكشف عنها الأيام القادمة، لكن المؤكد هو أن الشرق الأوسط يقف على مفترق طرق قد يُعيد تشكيل مستقبله الاقتصادي والسياسي لعقود قادمة. يمكن لبعض هذه السياسات أن تعزز النمو الاقتصادي أو ترفع التضخم أو كليهما. كما أن مدى تنفيذ ترامب لهذه السياسات وترتيبها يزيد من حالة عدم اليقين، ولا ينشأ التباطؤ الحالي في تدفقات رأس المال عن حدث مرتبط بالأسواق الناشئة، بل بسبب تشديد الظروف المالية على مستوى العالم لأن تعهدات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب عزز احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. فإن الضغوط على المالية العامة والتضخم والنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة سوف تشعر بها كل أركان العالم. من المتوقع أن تنخفض نسبة النمو العالمي بمقدار نصف درجة نتيجة الجائحة، وهو انخفاض كبير، وقد يشهد العالم ركوداً اقتصادياً واسعاً إذا ما استمرت الأزمة الناجمة عنها.
أعتقد أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء الصناعة الأمريكية على أساس مستقل استراتيجيًا بقدر الإمكان. إن فكرة تقليل اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الدول الأجنبية، وخاصة الصين، تتفق تمامًا مع أحادية أمريكا أولاً، وهذا هو السبب الأساسي وراء إعادة طرح فكرة الانفصال على طاولة المناقشات. المنطق واضح جدًا، ولكن من الناحية المالية، قد لا يكون الأمر بهذه البساطة.
لن يؤدي هذا إلى زعزعة استقرار الاقتصاد فحسب، بل إنه سيدمر مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي لا تزال ضعيفة بعد فشله في إدراك حجم عاصفة التضخم في عام 2025. وتلقى الدولار دعما من توقعات بأن سياسات إدارة ترامب المقبلة، التي تشمل تخفيف قيود تنظيمية وخفضا للضرائب ورفع الرسوم الجمركية والتضييق على الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو ومسببة للتضخم في نفس الوقت. لذي يُعتبر التحدي الأكبر للأمن والمصالح الأمريكية. في هذا المشهد العالمي المتغير، تقف اليابان في موقف دقيق، بين التحالف الاستراتيجي الوثيق مع واشنطن والعلاقات الاقتصادية العميقة مع بكين. فكيف ستتعامل طوكيو مع صراع النفوذ بين العملاقين؟ وهل ستتمكن من الحفاظ على توازنها وسط هذه العاصفة الجيوسياسية؟ إن أحد الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية لترامب هو إعادة التصنيع الأمريكي من خلال فرض تعريفات جمركية عالية على الواردات. وهناك ركيزة أخرى تتمثل في تعزيز الصناعات الدفاعية. يمكننا أن نتوقع التركيز بشكل كبير على تأمين سلسلة التوريد، مما يعني تقليل اعتماد أمريكا الاقتصادي على الصين.
لشيء الرئيسي هو أن هذه المعاهدات لن تعمل بعد الآن كضمانات للحصول على الحماية الأمريكية. الواقع أن الحجج التي نسمعها من الاستراتيجيين الجمهوريين تتلخص في فكرة مفادها أن أميركا لا ينبغي لها أن تلتزم بالدفاع عن بلد ــ حتى لو كان حليفا ــ إذا لم يكن بوسعها أن تفعل ذلك دون أن تتكبد عناء الإنفاق. بعبارة أخرى، ”سوف نحمي الحلفاء الأقوياء، ولكن ليس الضعفاء، الذين يشكلون عبئاً ومخاطر على مصلحتنا الوطنية“. ويبدو أن قوة الحليف سوف تقاس بنسبة الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنفاقه على الدفاع. وقد تكهن البعض بأن الحد الأدنى قد يصل إلى 3%. الفكرة الأساسية هنا هي أن أميركا لابد أن تشكل تحالفات مفيدة لأميركا. فأين الميزة في التحالف مع بلد لا تستطيع أميركا الدفاع عنه دون استنزاف قوتها؟ إنه أمر منطقي إلى حد ما.
فقد قال ترامب إن تايوان لابد أن تخصص ما يصل إلى 10% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع. من الواضح أن هذا لن يكون ممكنا، ولكن يبدو أن التفكير هو أن تايوان هي التي تتعرض للتهديد من قبل الصين، وإذا كانت تايوان تريد ردع الصين، فهي بحاجة إلى استثمار أكثر بكثير من نسبة 2 أو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي تنفقها دول حلف شمال الأطلسي. بالإضافة إلى اعتبارات الردع، إذا تمكنت واشنطن من إقناع دول مثل تايوان بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة من خلال ميزانياتها الدفاعية المتزايدة، فإن هذا سوف يتوافق بشكل جيد مع خطط ترامب لتعزيز النمو في الصناعات الدفاعية المحلية.
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا