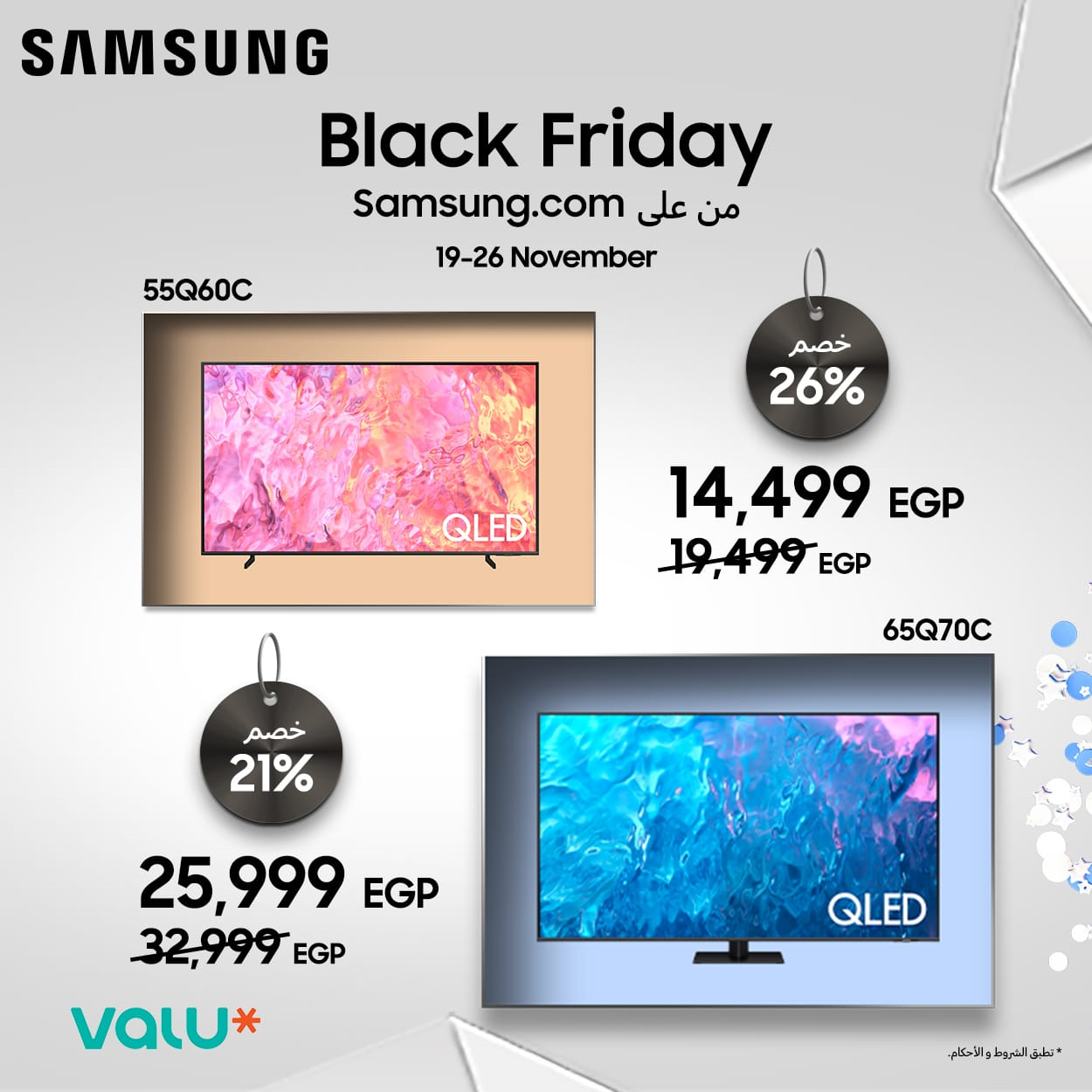لعله من الجدير بالذكر، فيما يخص النظرية النقدية الغربية، الإشارة إلى أن هذه النظرية، بآلياتها وأدواتها، ظلت ممتدة وسارية في نسغ جل الدراسات التطبيقية التي تناولت الإبداع الأدبي، قراءة وتحليلا، وقد شكل ظهور الشكلانية الروسية العلامة الفارقة في هذا الصدد، بحيث يمكن القول إنها أضحت بمثابة العمود الفقري، الذي يستند إليه كل ماجاء بعدها من إنجازات على صعيد الدراسات الأدبية والنقدية، بل الفكرية بعامة.
وبوسعك، أيها القارئ، أن تنظر بعين فاحصة إلى مقولات رواد الشكلية الروسية، حلقة موسكو ومدرسة براغ؛ فبوريس توماشفسكي في دراسته عن “نظرية الأغراض” يؤكد أن مفهوم المتن الحكائي يشير إلى مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل، وأنه يمكن عرض هذا المتن الحكائي بطريقة طبيعية، من حيث الترتيب الزمني والتصاعدي للأحداث المحكية، كما أنه يمكن أن يعرض باستقلال عن هذه الطريقة التي نظمت بها هذه الأحداث في العمل الأدبي.
وإذا نظرنا إلى تعريفه هذا، فسنجد صداه، في فترة مبكرة لدى جل المنظرين لنظرية الرواية، حيث يوجد لدى كل من أدوين موير في كتابه ” بناء الرواية”، وأيضا لدى إي. إم . فورستر في مؤلفه ” أركان القصة”، مرورا بكل من درسوا وجهة النظر في الرواية point of view، ك برسي لبوك في كتابه عن “صنعة الرواية”، وغيره، وانتهاء بإنجاز جيرار جينيت في “خطاب الحكاية”، الذي درس فيه المقولات الزمنية، وتقنياتها في الرواية الحديثة، من حيث عدم التقيد بالترتيب الزمني للأحداث، من تقديم وتأخير، واستباق وتواتر وغيرها، وهو ما أشار إليه توماشفسكي بالاستقلال عن الطريقة الطبيعية لتنظيم الأحداث.
وقد امتد هذا الإنجاز إلى دارسي الشعريات فيما بعد، ومن أبرزهم تزفيتان تودوروف، الذي كان له السبق في جمع جزء كبير من نصوص الشكليين الروس النقدية والفكرية، ضمن كتاب ” نظرية المنهج الشكلي ..نصوص الشكليين الروس”، وتمثل ذلك أيضا في كتاب تودوروف عن ” الشعرية”. ويلاحظ الدارس أيضا امتداد ذلك في أعمال رولان بارت في “النقد البنيوي للقصص”، وغيرها من الدارسين للسرديات الحكائية.
وإذا كان هذا حال بعض دارسي الغرب في ميدان السرديات، ففي تقديري أن جلّ دارسينا، سواء في الدراسات الأكاديمية أو المؤتمرات والندوات التي تناقش قضايا الأدب والنقد والنظرية، لا تزال تتكئ على تراث المدرسة الشكلية وأعلامها في تحليل الخطاب الروائي والقصصي، وأمامي مئات الدراسات في هذا الصدد، ومن الممكن الإشارة إلى دراسة قام بها أحد الدارسين المغاربة، وهو منصوري مصطفى، تحت عنوان “سرديات جيرار جينيت في النقد العربي الحديث”، الذي خلص فيه إلى أن”السرديات العربية تحتاج إلى إعادة قراءة مشروع جينيت وفق أسس جديدة، لا يقدم فيه مفصولا عن مشروع في كليته، فأعماله لا تنحصر في خطاب المحكي ولا تنتهي عند اقتراح إجراءات لتحليل مكونات الحكي، بل تمتد إلى محاولة استثمار الإجراءات ذاتها مع نوع من التحوير لقراءة ما هو أوسع من الخطاب وما هو أكثر تعقيدا من الحكي. ومن ثم فإن جينيت في النسخة العربية تبدو صورته ناقصة غير مكتملة تحتاج إلى بحوث أخرى لاستكشاف طبيعة تلقي النقد العربي لمتعالياته النصية ولأطراسة، وقبل ذلك لمسألة صياغته لمفهوم جديد لنظرية الأجناس، وأخيرا توقع صورته في النقد العربي بعد أن تحول إلى الجماليات”.
وإذا كان منصوري في دراسته المشار إليها قد أشار إلى أهمية إعادة تقييم ودراسة أعمال جنيت، وخاصة بعد تحوله إلى الجماليات، فإن ذلك أدعى مع كل المنظرين لنظرية النقد، سواء من الغربيين أو العرب، على معنى أننا نحتاج دائما إلى تقييم وتقويم دراساتنا النقدية، والفكرية بعامة، عبر نقد النقد.
وأقترح في هذا الصدد دراسة مشروع تودوروف النقدي وتلقيه في نقدنا العربي، بالاستناد إلى تطورات مشروعه وتحولاته الفكرية، ومن قبل ذلك إعادة دراسة مشروع ميخائيل باختين كاملا، وطرق تلقيه في النقد العربي، وأثره في دراساتنا البحثية والعلمية والثقافية، حتى نتبين موقعنا الحقيقي وإسهامنا في هذا المجال.